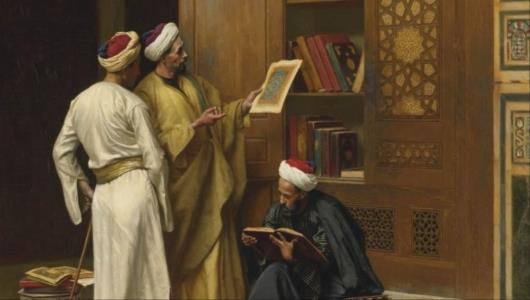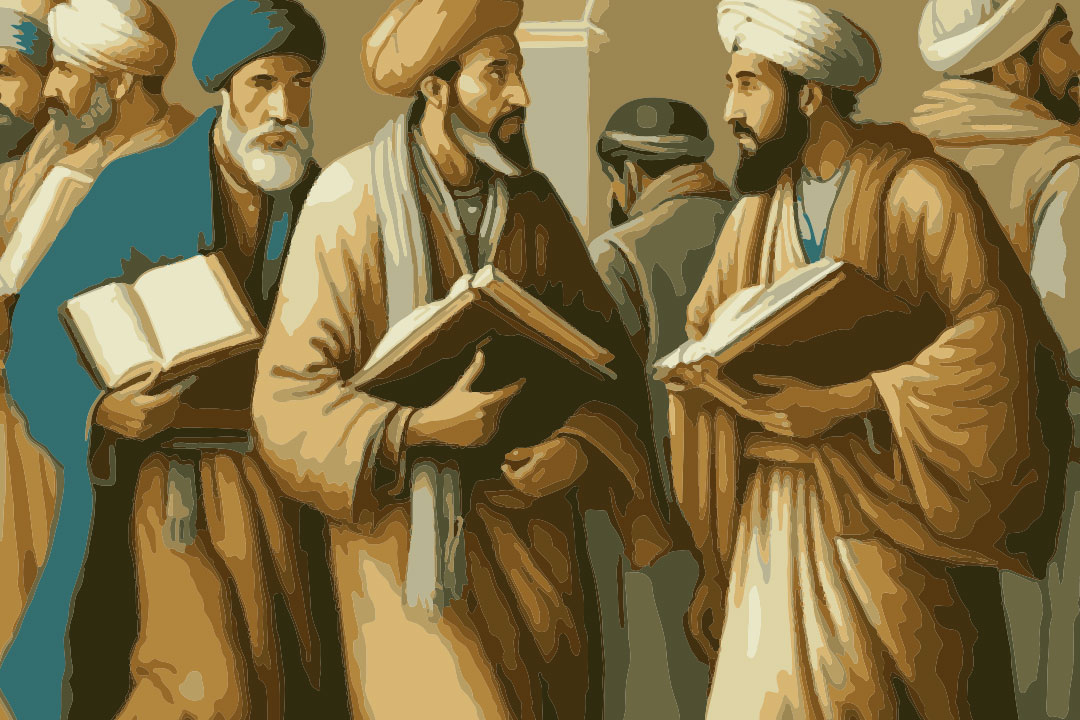المقدِّمة:
يدور جدل في الوسط الفكري المهتم بدراسة ظواهر التحوّلات الفكرية والمذهبية في المجتمعات الإسلامية، عمّا إذا كان التحوّل الذي شهدته اليمن منذ القرن التاسع الهجري الخامس عشر الميلادي في ظاهرة تحوّل عدد من مفكريها وأعلامها من إطارهم المذهبي الزيدي الهادوي (الشيعي) إلى الإطار السنّي؛ يعني الفكاك التام من المذهب الأصلي لهم، أم أنه مجرّد انفتاح على الآخر السنّي، مع البقاء في الإطار الأصلي ليس أكثر. ويوجد رأيان رئيسان في هذا المجال، يتبنى أحدهما القول بأن الأمر لا يعدو الانفتاح على الآخر (السنّي)، مع البقاء على الأصل المذهبي، على حين يذهب الرأي الآخر إلى القول بأن التحوّل كان باتاً، وإن كان ذلك لا يعني الانتقال من إطار مذهبي مصنّف على الشيعة، إلى إطار مذهبي آخر مصنّف على السنّة، بل طابع التحوّل هو التحرّر الفكري من التقيّد بأي من المذهبية الخاصة في أيّ من الإطارين، ومن ثمّ يصبح الانتقال إلى الفكر السنّي العام.
التعريفات الاصطلاحية:
1- المجدّدون: مجموعة محدودة من المجتهدين اليمنيين، الذين عاشوا بين القرون التاسع والثالث عشر الهجرية، والخامس عشر والتاسع عشر الميلادية، ويصنّفون في الأصل على المذهب الزيدي، قبل أن يشتهروا باجتهاداتهم المختلفة كليّة عنه.
2- المذهب الزيدي: المذهب الذي أسسه الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (ت:122هـ)، ولا يكاد يختلف في كليّاته عن الفكر السنّي، إلا في مسائل كلامية محدودة، وفي مسألة الخروج على الحاكم الجائر بالنسبة لأمهات مسائل الفروع الفقهية.
3- المذهب الهادوي: المذهب الذي أسسه الإمام يحيى بن الحسين القاسم الرسّي (ت: 298هـ)، لتصل به جملة اجتهاداته النظرية والعملية، في المذهب الزيدي إلى مستوى جعل منه ناسخاً فعلياً للمذهب الذي عُرِف به زيد بن علي، وتصبح من ثمّ نسبة مذهب الهادي إلى المذهب الزيدي أقرب إلى التسمية بالمجاز، نظراً لحجم التغييرات الكلية والجزئية، والواقع العملي في اليمن، ولاسيما في النظرية السياسية (نظرية الإمامة)، وحاصلها اشتراط البطنين (نسل الحسن والحسين من فاطمة)، مؤهلاً للحكم، قبل أيّ شرط آخر.
4- المذهب الزيدي الهادوي: تعبير يُقصد به – في هذا البحث – زيدية المذهب الهادوي المنتسب – مجازًا أو أقرب إليه- إلى الإمام زيد وفكره وفقهه، ومالم تدل القرينة على غير ذلك، كوجود اشتراك بين مذهب زيد ومذهب الهادي؛ فإن التعبير بالزيدية الهادوية في هذا البحث ، لا ينصرف إلا إلى ذلك المعنى الخاص بالهادي.
حرّية الاجتهاد في المذهب الزيدي الهادوي بين النظرية والتطبيق:
من المعلوم لدى الدارسين في حقل المذاهب الإسلامية أن سمة الانفتاح المعرفي في المذهب الزيدي الهادوي تعدّ واحدة من أبرز السمات التي تميّز بها المذهب ولو نظرياً على الأقل. ويقصد بتلك السمة عدم التثريب على المجتهدين المؤهلين من تبني القول الذي يقودهم اجتهادهم إليه. ولعل من أشهر الأقوال في هذا ما نص عليه أبرز مصدر فقهي زيدي هادوي وهو المعروف بـ(كتاب الأزهار) للإمام أحمد بن يحيى المرتضى (ت:840هـ)، حيث استهل متنه بقوله:
“التقليد في المسائل الفرعية العملية الظنية والقطعية جائز لغير المجتهد، لا له، ولو وقف على نصّ أعلم منه، ولا في عمليٍّ يترتّب على علميٍّ كالموالاة والمعاداة”(1).
وقوله: “وكل مجتهد مصيب في الأصح، والحيّ أولى من الميّت، والأعلم من الأورع…”(2).
وقوله: “والتزام مذهب معيّن أولى ولا يجب” (3).
ووفقًا لتعبير يحيى عبد الكريم الفضيل (أحد علماء الزيدية المعاصرين، ت:1412ه) فإن من قواعد الزيدية: “ تحريم التقليد على من بلغ درجة الاجتهاد، من العلماء، وتجويز التقليد كضرورة ملجئة لغير المجتهد”(4).
ويلفت المؤرّخ محمّد بن علي الأكوع الحوالي (ت:1419هـ/ 1998م) بعد تأكيده على مسألة ميزة الانفتاح في المذهب الهادوي؛ أن مما امتاز به المذهب “أيضاً أنه جاء عِلْماً مزيجاً بين التقليد والاجتهاد، ألّفوا كتباً في الفقه، حشروا فيها أقوال علماء الأمصار والصحابة وتابعيهم، ومن تفرّد في ذلك، أو لم يكن له أتباع، وجعلوا محور الكتاب على مذهب الهادي، يركّزون فيه المسألة، ثمّ يتناولون أقوال العلماء في تلك المسألة، مع الدليل والتعليل”(5).
وعزى أحد الباحثين في هذا الإطار إلى سمة الانفتاح هذه إتاحتها للمذهب الزيدي أن يتعامل بمرونة مع الدولة العثمانية في ظل حكمها العالم الإسلامي ومنه اليمن، حين عمّمت على قضاتها في كل ناحية القضاء وفق المذهب الحنفي، وفقاً لما نصّت عليه المجلة العدلية –حينذاك- المستقاة من المذهب الحنفي. ولما كان أبو حنيفة قد أخذ عن الإمام زيد وغيره من آل البيت بعض فقهه فلم تظهر مشكلة لدى قضاة المذهب الزيدي – وقتذاك- في أخذهم بأحكام المجلة العدلية (الحنفية)، بل تعاملوا معها بانسجام(6). لكن لئن صحّت هذه الحادثة فإن ذلك يُحمل – من وجهة نظري- على أنه كان سبيلاً اضطرارياً من سبل التعايش، أو أنه كان سبيل بعض حكّام الأئمة في مرحلة من المراحل، لا أنه كان منهجاً مطّرداً تجاه العثمانيين ومذهبهم، يُعزى إلى إيجابية العلاقة بين زيد وأبي حنيفة، ذلك أن العلاقة الفعلية التي طبعت تاريخ الزيدية الهادوية بالدولة العثمانية في مرحلتيها الأولى والثانية كانت علاقة عداء واحتراب وتربّص بالجملة، ولا شكّ أن لذلك انعكاساته العملية السلبية على طريقة التعاطي مع كل ما يصدر عن الدولة العثمانية، بما فيها مدونتها القانونية ومذهبها المعتمد، وهو المذهب الحنفي، حتى إن الحوثيين ليفخرون اليوم في مناهج التعليم الرسمي التي غيّروها بعد سيطرتهم على الدولة في 21سبتمبر/أيلول2014م بأن أبرز من قاوم ما يصفونه بـ” الاحتلال العثماني الأول” كان الإمام القاسم بن محمد (ت:1026ه/1598م)، على حين أن أبرز من قاوم المرحلة الثانية للعثمانيين أو ما يصفونه بـ” الاحتلال العثماني” كان الإمام الملقّب بـ”المنصور بالله” محمد بن يحيى حميد الدين (ت:1322هـ/1904م)، وكذا ابنه من بعده الإمام الملقّب بـ” المتوكل على الله” يحيى حميد الدين (ت:1367هـ/1948م)، ويلقّنون التلاميذ اليوم عبر تلك المناهج المبدّلة بأن اليمن سميّت منذ ذلك الحين بـ” مقبرة الأناضول”(7)، وأكثر من ذلك أورده الحوثيون في كتاب “الثقافة الوطنية” المقرّر على طلبة التعليم الجامعي، بوصفه –لدى الحوثيين القائمين على وزارة التعليم العالي في صنعاء- متطلبًا جامعيًّا إلزاميًّا، حيث زاد على ما سبق فوصف العثمانيين بـ”الدولة الاستعمارية”، وبالغ في ذمّها، مكرَّرًا مقولة “اليمن مقبرة الأناضول”(8)، وهو ما ألمح إليه بدر الدين الحوثي في كتابه “تحرير الأفكار”، حين نحى باللائمة للحيلولة دون نشر المذهب الهادوي في اليمن، على النَّحو الذي كان ينشده؛ إلى وجود معارضين للدولة الإمامية الهادوية أمثال القرامطة والمطرفية والأتراك(9)، ثمَّ تجسّدت تلك الروح العدائية، على نحو أكثر تعبيرًا عن روح الانتقام من الدولة العثمانية وجيشها، فقام الحوثيون في 12/3/2022م بالبدء في تحطيم النصب التذكاري التركي في ساحة العرضي بصنعاء، الذي يرمز إلى الجنود الأتراك، الذين قضوا في اليمن أثناء وجودهم فيها. وكان قد تمَّ افتتاح ذلك النصب بحضور الرئيس التركي السَّابق عبد الله جول، في عام 2011م، الذي علّق في صفحته على تويتر، على هذا المسلك الحوثي، في اليوم نفسه باستياء بالغ، كمّا عبرت الحكومة التركية عبر وزارة خارجيتها عن إدانتها الشديدة، لما وصفته بـ “الاعتداء الغادر”، على النصب التذكاري لمقبرة الشهداء الأتراك في صنعاء.
وبعيدًا عن هذا الاستطراد الذي فرضه ذلك الزعم بتناغم المذهب الهادوي مع المذهب الحنفي في ظل نفوذ الدولة العثمانية؛ فإن ذلك لا ينفي أن سمة الانفتاح المعرفي في المذهب الزيدي الهادوي، إلى جانب عامل الإشكال الكلي في بنية المذهب التي يعلمها المحققون في المذهب؛ دافع عملي تسبب في تخريج أئمة وعلماء مجتهدين تجاوزوا المذهب، وانتقل تأثيرهم إلى بيئات إسلامية أخرى، بل صاروا أعلامًا على مستوى العالم الإسلامي، أمثال محمد بن إبراهيم الوزير (ت: 840هـ- 1436م)، والحسن بن أحمد الجلال ( 1084هـ- 1673م)، ومهدي بن صالح المقبلي (ت:1108هـ-1696م)، ومحمّد بن إسماعيل الأمير الصنعاني (ت:1182هـ-1768م)، ومحمّد بن علي الشوكاني (ت:1250هـ-1834م)(10). وهم وإن دفعوا جميعا ثمن تحررهم غاليًا- كما سترد الإشارة لاحقاً- إلا أنه لا يُنكر أنه لولا تلك السمة في أصول المذهب الزيدي الهادوي لما تمكنوا ابتداءً من البحث والتأهيل حتى بلغوا تلك الدرجة!
لقد قام هؤلاء المجدّدون بعملية مراجعة علمية فكرية جسورة، -قبل أن تكون فقهية- للموروث البيئي من كل جوانبه، فألفوا ما يستأهل المراجعة والتقويم، حتى أفضى بهم الأمر إلى اختطاط مسار آخر، مختلف عن مسار المذهب الزيدي الهادوي، في جملة الأصول والفروع، ومصادر التلّقي، ومنهج الاستدلال.
الهوامش:
- أحمد بن يحيى المرتضى، كتاب الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، د.ت، د.ط، د.م. د.ن، المقدّمة (مقدّمة لا يسع المقلد جهلها) ،ص10.
- أحمد بن يحيى المرتضى، لمصدر السابق، ص 10.
- أحمد بن يحيى المرتضى، المصدر نفسه، ص 14.
- يحيى عبد الكريم الفضيل، من هم الزيدية، 1401هـ-1981م، الطبعة الثالثة، عمَّان، جمعية عمّال المطابع التعاونية، ص9.
- محمد بن علي الأكوع الحوالي، اليمن الخضراء مهد الحضارة، 1402هـ- 1982م، ط الثانية، صنعاء: مكتبة الجيل الجديد، ص 105.
- محمّد أحمد الكبسي، الفروق الواضحة البهيّة بين الفرق الإمامية وبين الفرقة الزيدية، 1413هـ-1992م، د.ط، د.م، د:ن، ص 61-62.
- وزارة التربية والتعليم (الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء) الإدارة العامة للمناهج، كتاب التربية الوطنية للصف الخامس من مرحلة التعليم الأساسي، طبعة 1442هـ/2021م، الدرس الأول: اليمن مقبرة الغزاة، ص 8، 17.
- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (الخاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء) ،الثقافة الوطنية،2020م، ،د. ط، د.م: د.ن، ص 51-59.
- بدر الدين الحوثي، تحرير الأفكار (تحقيق : جعفر العاملي)، د.ت، ط الثالثة، د:م، المجمع العالمي لأهل البيت، ص 299.
- إسماعيل الأكوع، الزيدية: نشأتها ومعتقداتها، 1413هـ-1993م، ط الأولى، بيروت: دار الفكر المعاصر، ص 34-35.